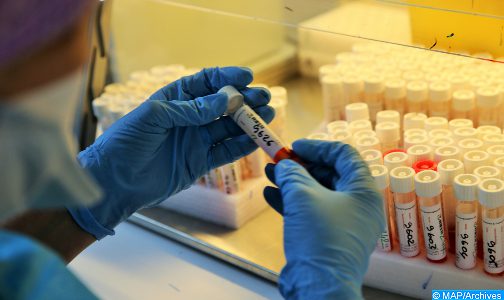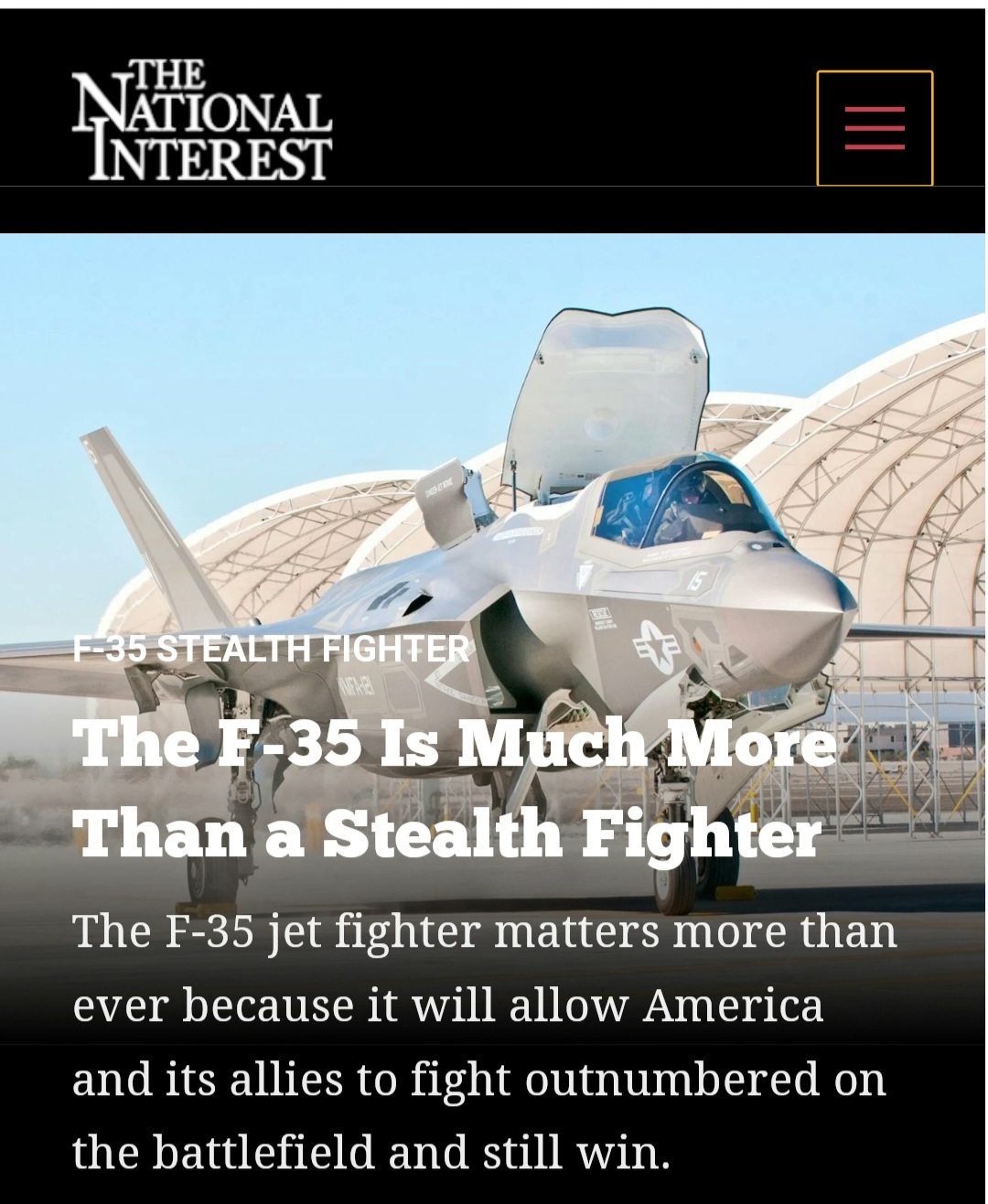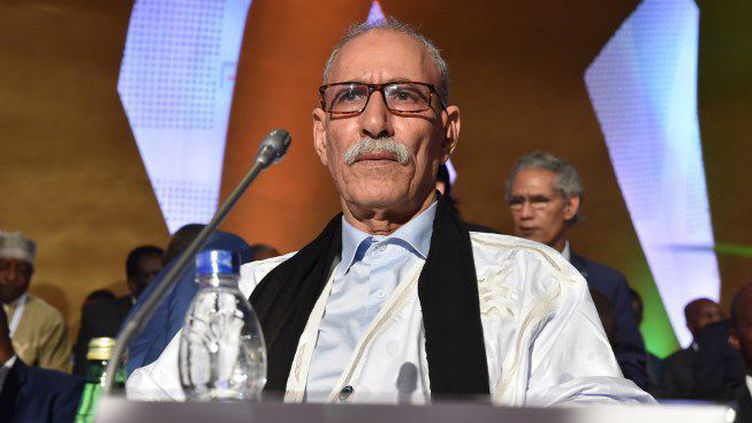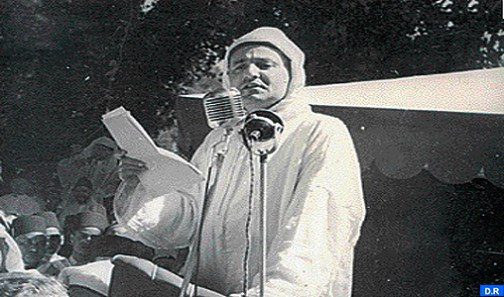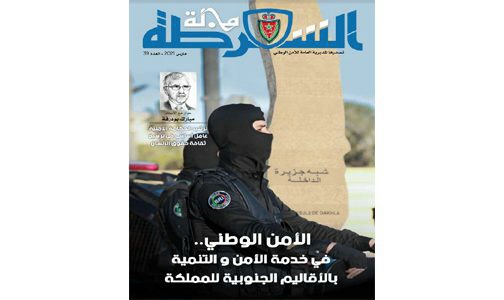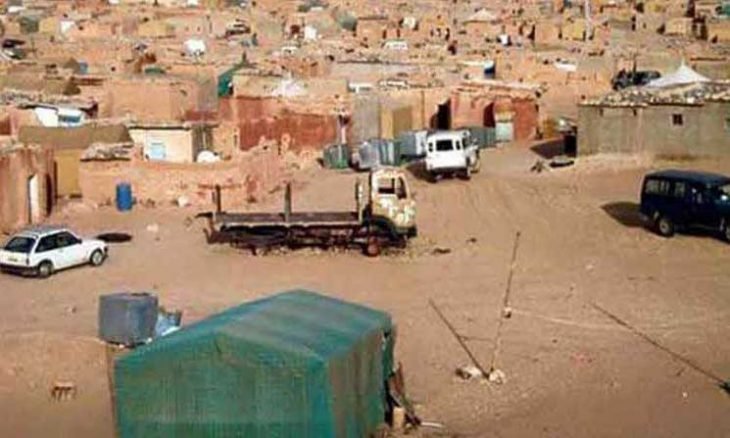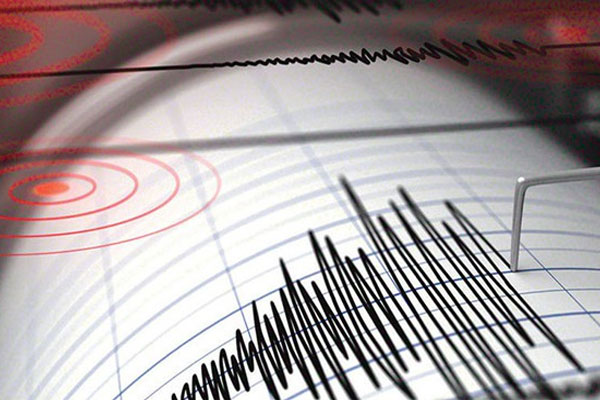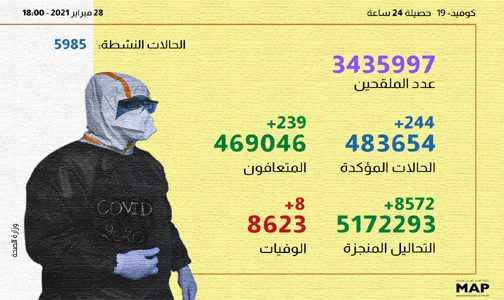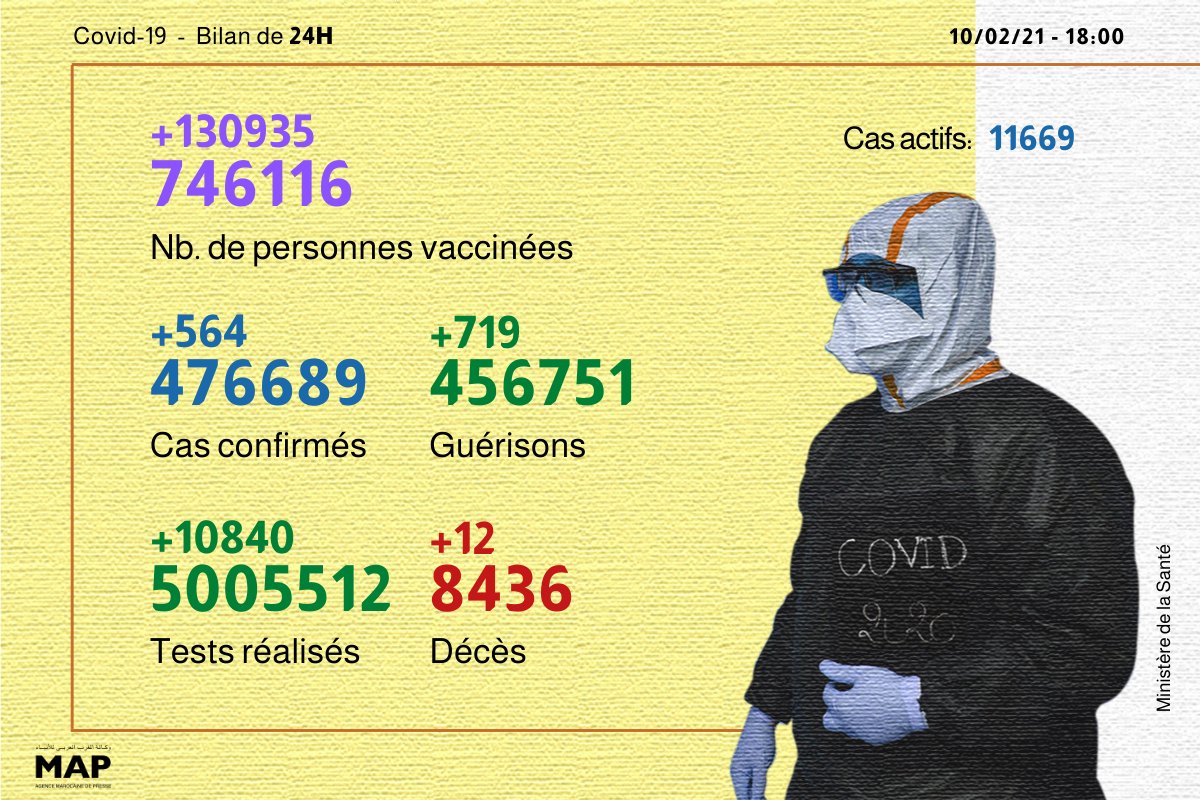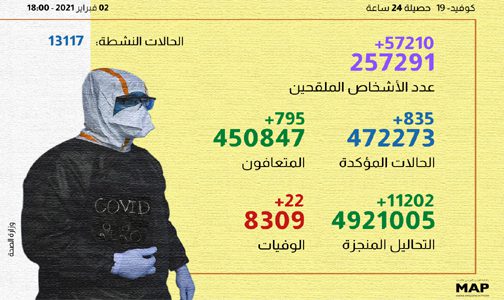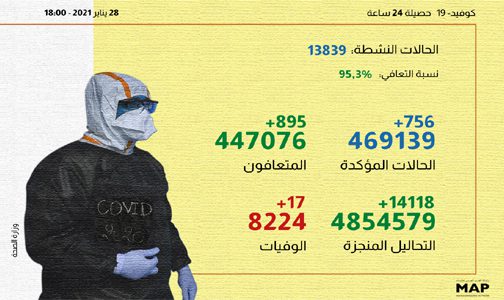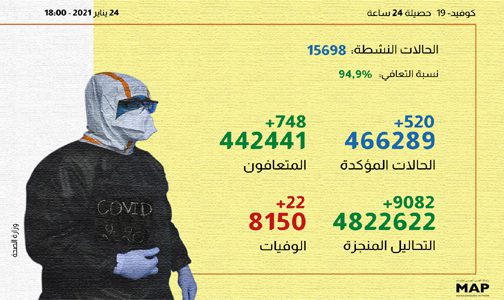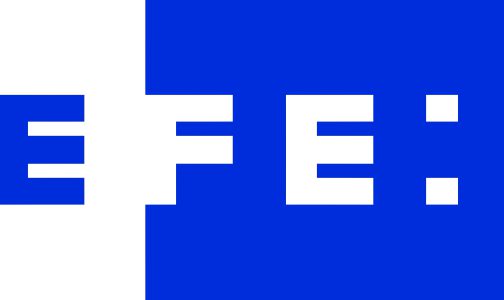وزارة الخارجية الأرجنتينية: المغرب يتموقع كسوق استراتيجية بالنسبة للأرجنتين
أكورا بريس- و . م .ع
يعد سلوك الاستهلاك البشري عملية حيوية مرتبطة بالاحتياجات اليومية لكل إنسان، ورحى تتداخل فيها الأبعاد النفسية والسوسيولوجية والاقتصادية والهوياتية بشكل عضوي، مما يجعل تمظهرات الاستهلاك من حيث الكم والنوع في المجتمعات تعبيرا عن طبيعة القيم والعادات التي تحكم أفرادها.
في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، يسلط الباحث في علم الاجتماع وأنثربولوجيا الثقافة الدكتور عياد أبلال، الضوء على ظاهرة الإفراط في الاستهلاك، لا سيما خلال شهر رمضان الأبرك وذلك من خلال الأسئلة التالية:

1 – تلاحظ خلال شهر رمضان ظاهرة الإقبال الكبير على اقتناء المواد الغذائية واستهلاكها وربما الاقتراض من أجل ذلك، كيف يمكن تفسير سلوك الإفراط في الاستهلاك إلى حد التبذير وهدر الطعام في شهر في رمضان؟
مع كل رمضان، يشهد المغرب، عددا من الممارسات والطقوس، المرتبطة بالصيام، والتي باتت لصيقة بالتدين المظهري، مما يسيء في العمق إلى روحانية هذه الطقوس التعبدية، كما يسيء إلى صورة المسلمين عموما، خاصة وأن هذا التدين ميزة المجتمعات العربية بشكل عام، وليس المغرب فقط، وتغدو العلاقات الاجتماعية، محلالاً لهذا التدين المظهري/الكرنفالي، فإذا كان شهر رمضان شهراً مقدساً عند المسلمين، فإنه، بعد إفراغه من محتواه الروحي الذي لا ينفصل عن بعده المدني والأخلاقي، قد يتحول إلى مجرد طقس اجتماعي بدون دلالة روحية، مما يجعله لا يخلو من عنف بشتى أشكاله، ولعلنا نجد في الإفراط في الاستهلاك أحد تجليات هذا العنف الاستهلاكي، الذي بموجبه يتحول الاستهلاك إلى وسيلة لتعميق الحيف والاستبعاد الاجتماعي لصالح من له القدرة على الاستهلاك، في حين يشتد الإحساس بالقهر والدونية عند من لا يستطيع إلى الاستهلاك سبيلا.
وإذا كان الدين عملياً أحد أهم العوامل المساعدة على تخليص الإنسان من التوتر وتبديد طاقة التدمير والكراهية والأنانية لديه وتحويلها إلى طاقة للحياة والمحبة والإخاء، خاصة إذا ترافقت أشكال التدين بالتأمل الروحي، باعتباره جوهر الدين الذي يجعل الإنسان يرتقي إلى مستويات راقية من المدنية والسلم، كفيلة بإشاعة قيم المحبة والخير، فإن هيمنة البعد الفرجوي والكرنفالي لأشكال التدين المختلفة، باختلاف الثقافات والسياقات على الجانب التعبدي، يجعل التدين نفسه عاملا ومسرحاً لشتى أنواع الانحرافات. من هنا، يصبح شهر رمضان بالرغم من قدسيته وروحانياته مناسبة للاستعراض والتباهي الاستهلاكي، وهو ما يفرغ رمضان من أبعاده الزهدية، ويجعله، مع الافراط في الاستهلاك، مفرغا من فلسفته الدينية، ذلك أن فلسفة الصيام الدينية هي إحساس المؤمن بالجوع والعطش، وهو في العمق دعوة الله لعباده لتدبر الفقر والحاجة، بما هي دعوة إلى الإحساس بالفقير، ودعوة للتكافل والتضامن، خاصة وأن التفرغ للعبادة والتنسك يجعل المؤمن أقرب إلى الله، ومن ثم أقرب إلى فعل الخير والحسنات، وفي ذلك سن الله سبحانه وتعالى عددا من القوانين المنظمة للعلاقات بين المؤمنين والمسلمين، خاصة بين الفقراء والأغنياء، الذين جعل الله في أموالهم حقاً للسائل والمحروم. بيد أن إفراط الناس في الاستهلاك جعل هذا السلوك يتحول عبر الجبر والقسر الاجتماعي إلى قاعدة، وهي قاعدة اجتماعية جعلت الناس يدخلون في صراع التباهي المظهري عبر مائدة الافطار والعشاء والسحور، بما يتجاوز الوظيفة الحيوية للغذاء إلى الوظيفة الاستعراضية، وهو ما جعل من هذه الأخيرة حاجة اجتماعية، وهو ما يفسر اقتراض بعض المغاربة من أجل قضاء شهر رمضان، وهو الميكانيزم الاجتماعي نفسه الذي يشرح استهلاكية الأعياد في المغرب، بما في ذلك عيد الأضحى، بالرغم من أنه سنة وليس واجباً.
2- ما هي الأسباب السيكولوجية والسوسيولوجية لهذه الظاهرة؟
في سياق علم الاجتماع اليومي، يعتبر الاستهلاك محلالاً سوسيولوجيا لدراسة المجتمعات وتطورها، ومعرفة بنياتها التحية كما الفوقية، ومن ثم معرفة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا السياسية التي مرت بها هذه المجتمعات، فإذا كان الاستهلاك سلوكا فردياً في ظاهره، مرتبطا بنسق الشخصية، فإن هذا النسق في فردانيته لا ينفصل عن النسق الثقافي والنسق الاجتماعي، عبر ما يسميه إميل دوركهايم بجبرية السلوك الاجتماعي وعموميته، بحيث يتحول الاستهلاك إلى ثقافة اجتماعية تتميز بطابع الإكراه، مثله في ذلك، مثل باقي السلوكات الاجتماعية، حيث تلعب مؤسسات التنشئة الاجتماعية من الأسرة إلى المدرسة، مروراً بالإعلام دوراً كبيراً في صياغة ثقافة الاستهلاك، في اتصال وثيق بصياغة البراديغم الاجتماعي، بحيث تصير القولة المأثورة: “دير كيف دار جارك ولا حول باب دارك” رمزاً تلخيصياً لهذا البعد الإكراهي للبراديغم الاجتماعي للاستهلاك.
إننا لا نستهلك فقط لنعيش، بل نستهلك لنحيا ضمن دوائر رمزية شديدة الصلة بثقافة المجتمع وميولاته ونزوعاته المادية، وهو الإطار الذي يشتغل في فلكه “الإشهار”، و”الموضا”، و”الإثارة”، و”البوز”، خاصة مع تحول شبكات التواصل الاجتماعي إلى آلية جديدة للقهر الاجتماعي، وهنا يتأسس الاستهلاك على الفعل ورد الفعل، على المثير والاستجابة، ضمن رؤية سلوكية لا تترك الفرصة للمستهلك لمساءلة ما يستهلكه، ومن ثم تقييم سلوكاته الاستهلاكية، بحيث تتحول سلوكات النخبة الاستهلاكية الموجِهة، التي تديرها صناعة الاستهلاك على المستوى العالمي، إلى سلوكات فرجة الجمهور، ويتحول المجتمع من مجتمع السترة والكفاف والعفاف والبركة إلى المجتمع التفاخري، بما هو بالنهاية مجتمع الفرجة. ويتحول كل مستهلك إلى مستشهر لبضاعة أو ماركة أو منتوج، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي عرفها الاتصال والتواصل في ظل العولمة، وتحديدا العولمة الرقمية، التي وجدت ضالتها في الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أحد أهم آليات هذا التحول في ثقافة الاستهلاك، بحيث يصبح نسق الشخصية على المستوى السيكولوجي رهينا بنسق الثقافة والنسق الاجتماعي، ومن هنا يقع تحول كبير في متطلبات نسق الشخصية، إذ تتوسع دائرة المتطلبات الحيوية لتشمل متطلبات كمالية زائدة، ويصبح الإفراط في الاستهلاك حاجة ملحة. وبذلك تتضخم حاجيات الجسد المادية وتحدث بالضرورة خللا وظيفيا في الجهاز النفسي والروحي للإنسان. وهوما نعبر عنه بالخلل الوظيفي الذي يحدث في نسق الشخصية، ومنه في النسق الثقافي والاجتماعي.
3- هل تساهم الإعلانات والتسويق اللتجاري في إذكاء هذا التهافت والاقبال المفرط على الاستهلاك والاقتراض أيضا في هذه المحطة الدينية السنوية؟
ربطا بالسؤال السابق، يمكن القول إن الدعوة إلى الاستهلاك أصبحت في إطار النيوليبرالية دعوة للتميز الاجتماعي والثقافي، ومن ثم تشكل الإعلانات والإشهار استراتيجية رأسمالية لترسيم وتكريس مجتمعات الفرجة، وهي مجتمعات تحولت في ظلها الطقوس الدينية إلى طقوس كرنفالية، حيث أفرغ الدين من محتواه الروحي والمدني، ومن قيمه الأخلاقية، وهي قيم كانت تميز المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات في مرحلة ما قبل العولمة ورقمنة التواصل، بحيث كلما اشتدت وسائط التواصل الرقمية، كلما انتفى التواصل. وكلما تحول التدين إلى فرجة واستعراض طقوسي وكرنفالي، كلما انتفى الدين، خاصة في البلدان التي انتقلت من ثقافة الأذن إلى ثقافة العين دون المرور عبر مرحلة التأسيس للمعرفة.
عمليا مر المغاربة، مثلهم مثل باقي المجتمعات النامية، من مراحل وتحولات شملت ثقافتهم الاستهلاكية، التي ارتبطت في البداية بتلبية حاجياتهم الحيوية من ماء وغذاء ولباس في حدود وظائف هذه الحاجيات الحيوية، بحيث ظلت الكماليات حكراً على نخبة محدودة العدد من الأثرياء والأغنياء، الذين احتكروا في البداية دوائر الاستهلاك الرمزي، باعتبارهم مالكين للرأسمال المالي، والاجتماعي وكذا الثقافي، عبر استهلاكهم لمنتوجات رمزية خدماتية، من فنون بمختلف أشكالها وأجناسها…، كما استفادوا من خدمات ترويحية من سفر واستجمام وسباحة…إلخ، وهم الطبقة الأولى التي استفادت من خدمات الهواتف والحواسيب وما يرتبط بها من شبكات تواصلية، بحيث شكلت نموذجاً اجتماعياً للقدوة، سرعان ما أثرت في البنية الفوقية للمجتمع، خاصة مع تحولات الرأسمالية والليبرالية، التي سرعان ما جعلت من تعميم ثقافة الاستهلاك وعولمته وسيلتها لمضاعفة الأرباح وغزو الأسواق والمجتمعات، عبر تنميط الاستهلاك وتوحيد الأذواق، إذ أصبحت مجاراة “الموضا ” والإشهار ثقافة اجتماعية عامة، وتحولت الكماليات إلى حاجيات حيوية.
ضمن هذا السياق تحول شهر رمضان من مناسبة دينية تعبدية، تقتضي التقشف في الاستهلاك إلى مناسبة للإشهار والإعلان والاستعراض، بحيث تأسس نمط جديد من التدين الاستعراضي، وتحولت بذلك مائدة الإفطار إلى باحة استعراضية، خاصة مع المجتمع الرقمي، إذ أصبح تصوير موائد الإفطار وعرضها على شبكات التواصل الاجتماعي موضا وسُنة اجتماعية، فرضت على جزء من المجتمع المغربي في إطار ثقافة الجمهور الاستهلاكي براديغم اجتماعي يصعب التخلص منه.
ففي رمضان -كما في عيد الأضحى- تكثر إعلانات الاقتراض من مؤسسات قروض الاستهلاك بعروض تنافسية، كما تكثر إعلانات الأسواق الممتازة في الغذاء كما في اللباس، وهو ما لم ينتبه إليه الإعلام التلفزي نفسه، إذ تستغل وصلات الإشهار هذا التعطش للاستهلاك عند الناس لتوظيف صور البذخ في الاستهلاك والفرجة، وهو ما يحول رمضان من مناسبة دينية استثنائية للتعبد الروحي والأخلاقي إلى مناسبة استهلاكية وإشهارية، حيث تصبح للإشهار سلطة ثقافية واجتماعية تتجاوز سلطة الأسرة والمدرسة.