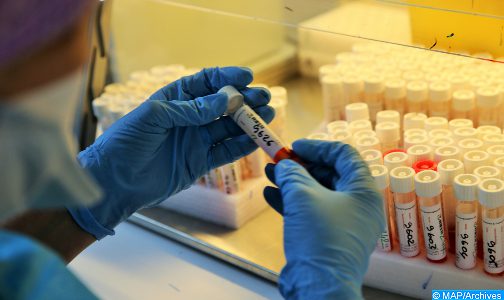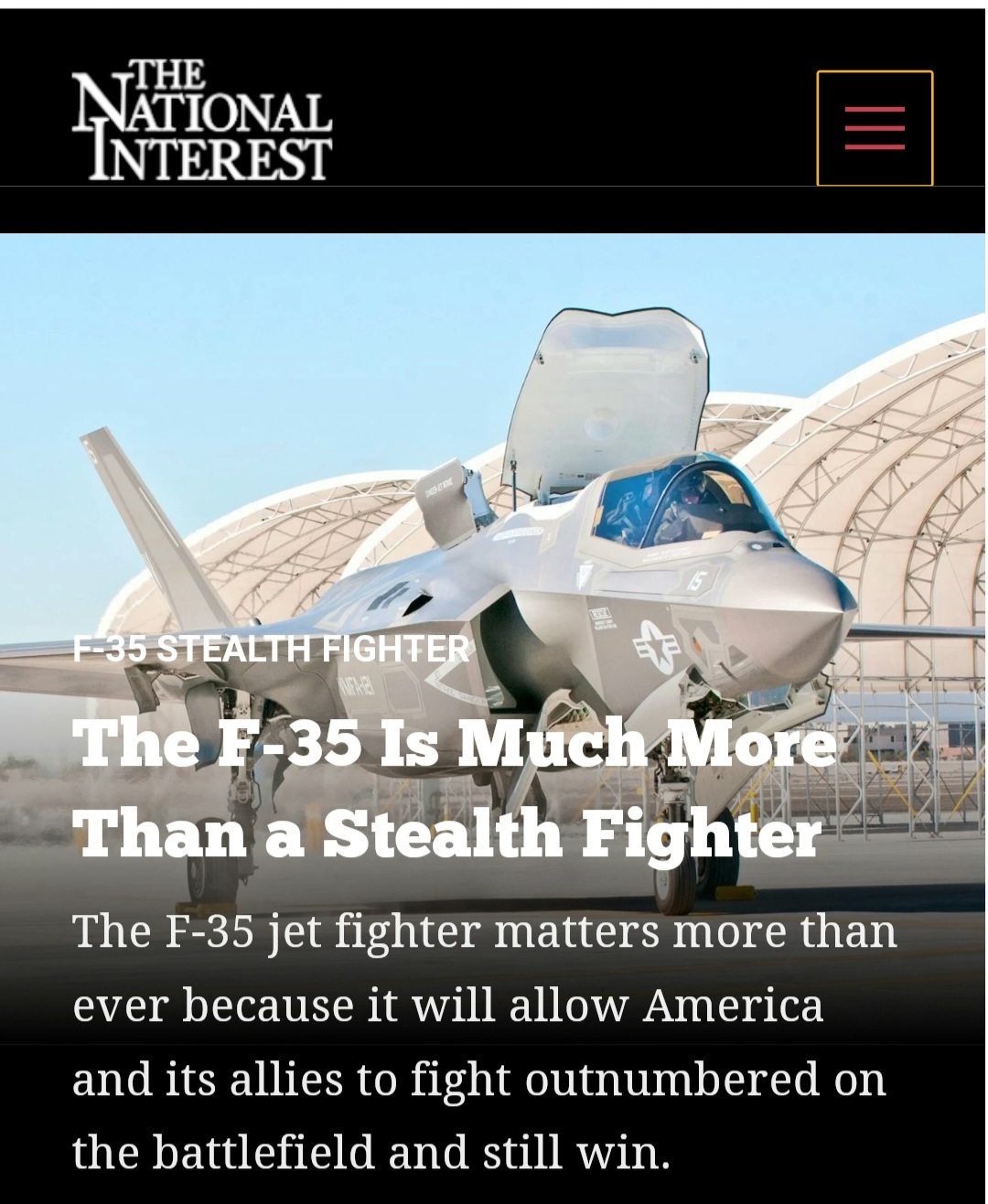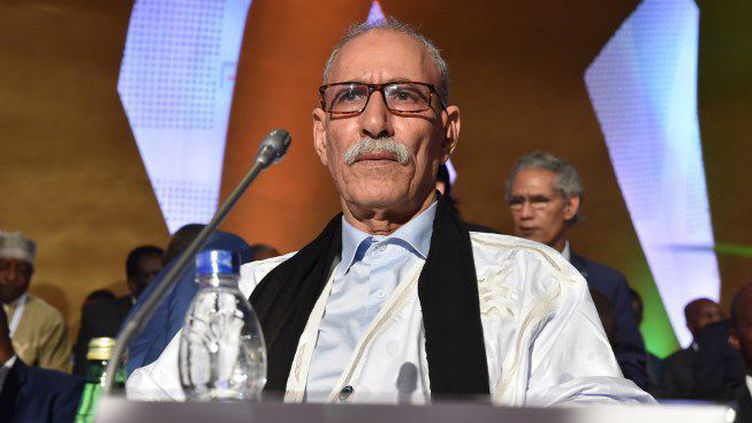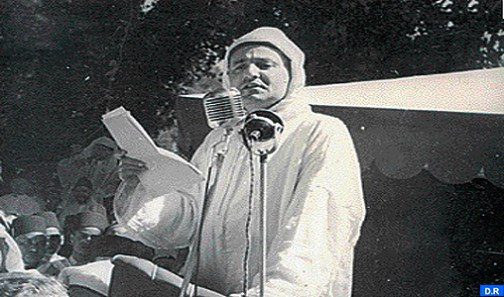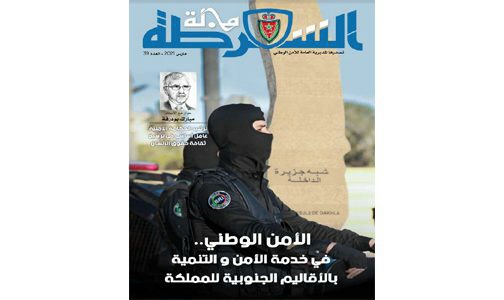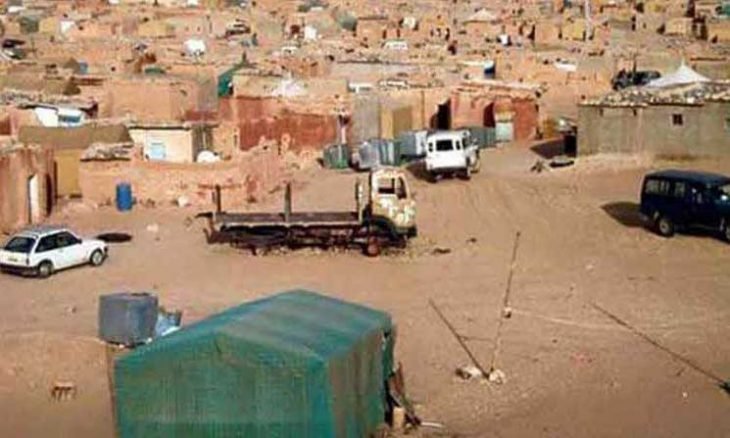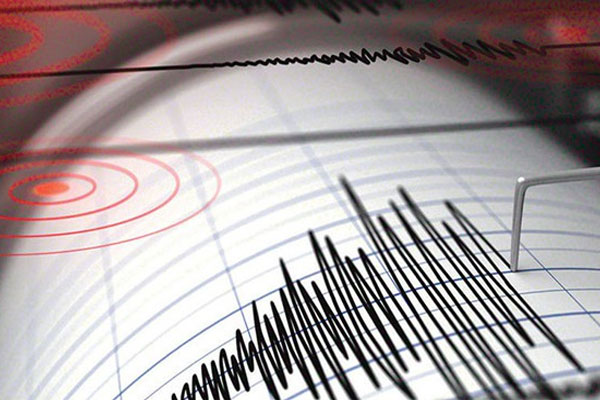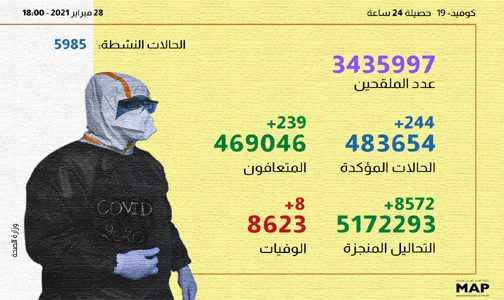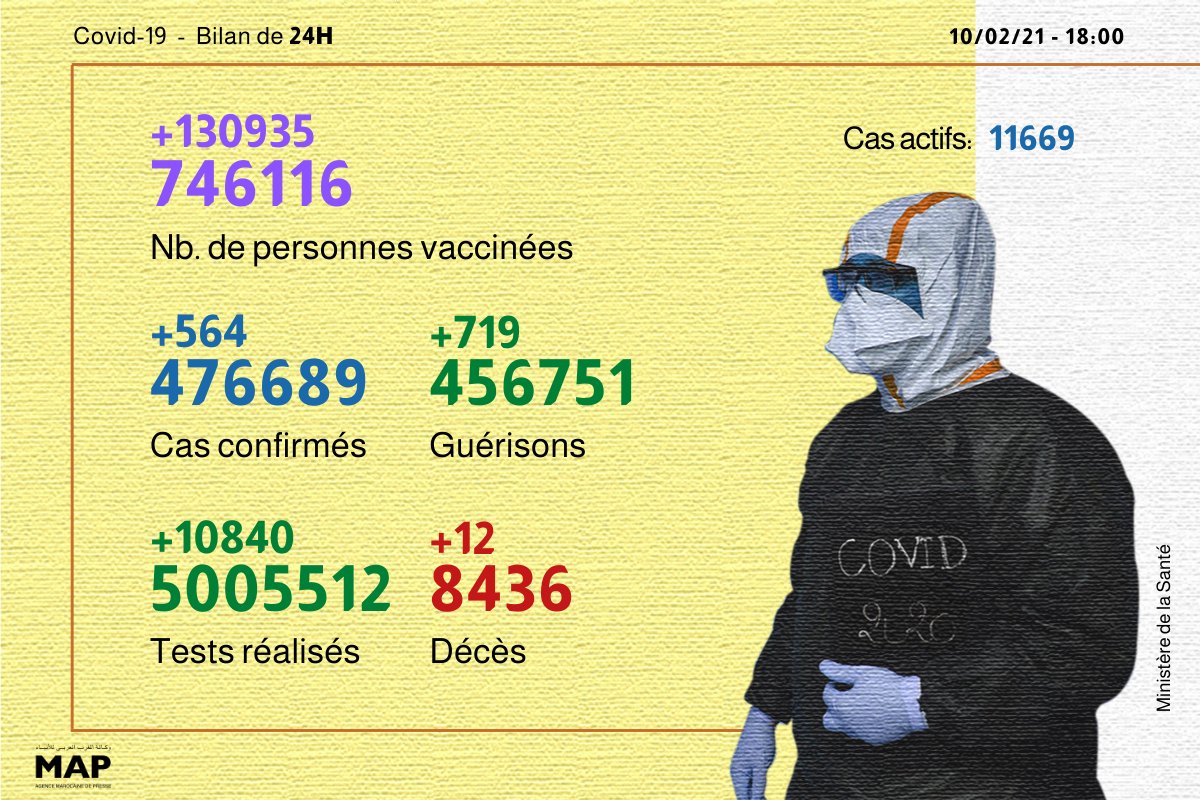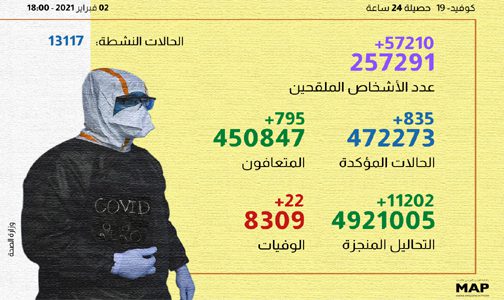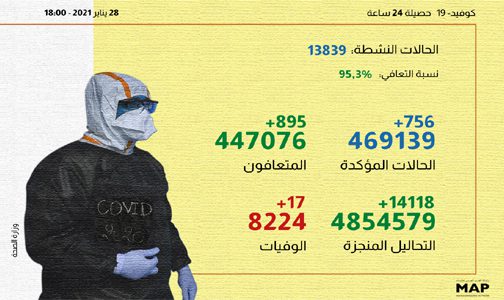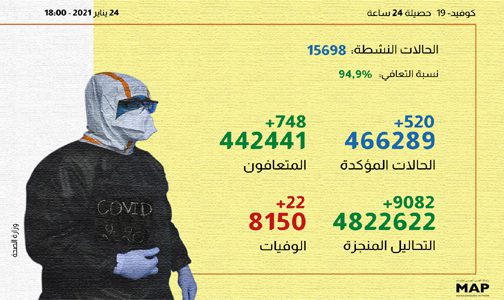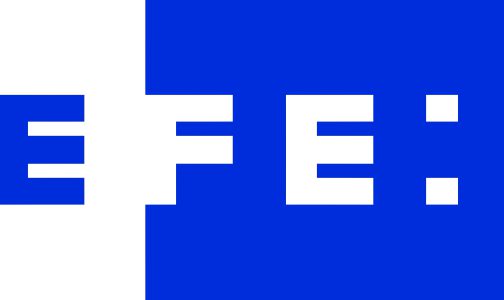برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محسن جمال
بقلم: جمال الموساوي
عندما يتعلق الأمر بالموت، يصبح الاحتماء بالشخصي والخاص أكثر الوسائل المتاحة لمقاومة النسيان. إذا كان النسيان آفة الذاكرة، فهو لا يجد إلى القلب سبيلا. لأن القلب هو الذاكرة الخاصة التي تحتفظ بكل شيء جميل. لهذا عندما تتلقى خبرا مثل وفاة عبد الجبار السحيمي لا يمكن إلا العودة إلى شريط طويل، فيه الكثير من الإشراقات.
للصداقات، عندما تكون صافية، أدوار مضيئة في الحياة. هذه الصداقات هي التي قادتني، بدوافع مهنية إلى عبد الجبار السحيمي. إلى جريدة العلم. لأن الدوافع الإبداعية كان الشاعر نجيب خداري قد فتح لها الباب قبل ذلك بكثير.
في يونيو 1995 أنهيت سنوات الإجازة في شعبة الاقتصاد بكلية الحقوق بالرباط. الأزمة الاجتماعية في المغرب وتداعيات التقويم الهيكلي كانت واضحة، لهذا كان الحصول على الإجازة يشبه القفز في المجهول. لم يتغير الأمر كثيرا الآن، لكن ثمة الكثير من الشّعاب التي يمكن سلكها مقارنة مع ما كان.
أكثر ما يحتاج إليه المرء في تلك الحالات يدٌ تمتد إليه. اسمي الأدبي الصغير، الإجازة في الاقتصاد، يدٌ صديقة، وعبد الجبار السحيمي. هذا ما كان يلزمني كي لا أفكر في مقاهي تطوان التي سبقني إليها، بكل أسف، الكثير من الأصدقاء ممن كانوا أسوأ حظا مني. كان التفكير في تلك المقاهي أسوأ شيء يمكن أن أستسلم له.
لحسن الحظ، حظي طبعا، توفرت لي تلك العناصر الأربعة: اسم أدبي صغير احتضنته الجرائد، وسهر على إنضاجه و”توسيع إشعاعه” أساتذة لهم في القلب تقدير لا يحدّ: فراس عبد المجيد، نجيب خداري، عبد القادر الشاوي وآخرون. إجازة في الاقتصاد. يد صديقة هي يد الصحفي مصطفى حيران، حيث فتح لي مجالا واسعا لترجمة مقالات متنوعة من الصحافة الفرنسية لصفحة “من كل الآفاق” التي كان يشرف عليها في ذلك الوقت. ثم بالتأكيد، عبد الجبار السحيمي، الذي عندما ألح علي الصديق حيران بمفاتحته في أمر فتح “ملف” في العلم تؤدَّى لي من خلاله “أتعاب” الترجمات التي أنجزها، لم يزد عن الموافقة على ذلك وبأثر رجعي.
هكذا بدأت الرحلة مع عبد الجبار السحيمي. وإذا كانت الأرزاق كما الأعمار بيد الله، فقد طلبني بعد أقل من شهر من موافقته على العمل بالقطعة لألتحق بالعلم بشكل رسمي، ووجدته يدافع عن ملفي لدى مدير شركة الرسالة التي تصدر العلم ولوبنيون للإشراف على قسم الإشهار في الجريدة. لم يسألني عما إذا كنت منتميا للحزب، ولا عما إذا كان آبائي الأولون قد فعلوا ذلك، ولم يطلب مني أن أفعل.
هكذا وقعت عقد العمل، للإشراف على قسم الإشهار في العلم، لكن عبد الجبار السحيمي أبقى على الأتعاب التي كنت أحصل عليها مقابل الترجمات ومقابل كل مقال أو عمود. ولأنه اعتبرني دائما صحفيا قبل كل شيء، واظبت على العملين: الإشهار والكتابة. مشرف مؤقت على قسم الإشهار في جبة صحفي مهني أكتب كل ما يعن لي في الثقافة والاقتصاد والسياسة ولم يسبق أن قال إن ثمة حدودا لم يكن عليك أن تتجاوزها. كان هذا نوعا من التقدير والثقة من جانب الأستاذ عبد الجبار السحيمي.
عندما صدرت مجموعته القصصية الأخيرة “سيدة المرايا”، وكان فرحا بها كما يفرح طفل بهدية صغيرة، كتب لي فيها إهداء مقتضبا، على غرار كتاباته الصحفية والإبداعية الخالية من كل حشو. “الأخ جمال الموساوي… أتمنى أن تحظى هذه المجموعة برضاك، وأنتظر رأيك إن أمكن. مع دائم المودة.”. كان هذا أيضا ترجمة لذلك التقدير الذي جعلني دائم الامتنان له.
هذا الامتنان، هو نفسه الامتنان الذي يمكن أن تشعر به تجاه أستاذ يعطيك ما يمكن أن يساعدك على النجاح دون مقابل يذكر. يعلمك، حتى دون أن يقول لك، كيف تصطاد سمكة في بحر الكتابة الواسع والمليء بالمطبات. يكفي منه ثناء مقتضب على عمود أو على مقال، أو على فكرة في أحدهما، ليشعرك أنك في الطريق المثلى. تلك كانت منهجية المدرسة التي ساق إليها الكثيرين ممن يبحثون لأنفسهم عن أفق في محراب الكتابة، لينطلقوا في السماء الواسعة. تصادف أنني كنت واحدا من هؤلاء !
ألم أقل إنه عندما يتعلق الأمر بالموت، يصبح الاحتماء بالشخصي والخاص أكثر الوسائل المتاحة لمقاومة النسيان؟. أجل. لقد فتح عبد الجبار السحيمي، أمام الكثيرين منا باب الحياة، إلى جانب توسيع باب الكتابة. صحيح أن الاسم الأدبي الصغير الذي يعلن عن نفسه في العلم والاتحاد الاشتراكي وأنوال وغيرها كان حاضرا، لكنه كان في حاجة ليد صديقة وأيضا لعبد الجبار السحيمي ليبدأ رحلة حياة البشر العاديين التي لا علاقة لها بأوهام المبدعين. الحياة يوما بيوم، خاصة عندما “تجرب أن تجري، وتقفز، وتطير إذا أمكن، لكنك تفعل ذلك بدون جدوى، لأن كل الطرقات مقفلة ويملأ الضباب جنباتها”. هذه قصة أخرى، بقدر ما تنتمي إلى الخاص فهي جزء من المشترك بين الكثير من الزملاء سواء الذين غَادَرْنَا العلم أو الذين لا يزالون هناك.