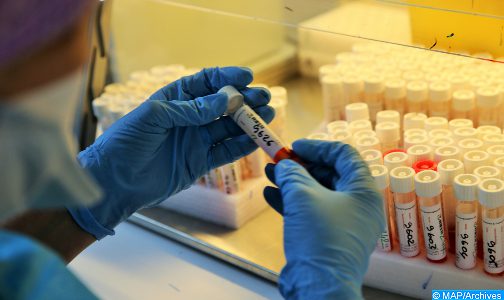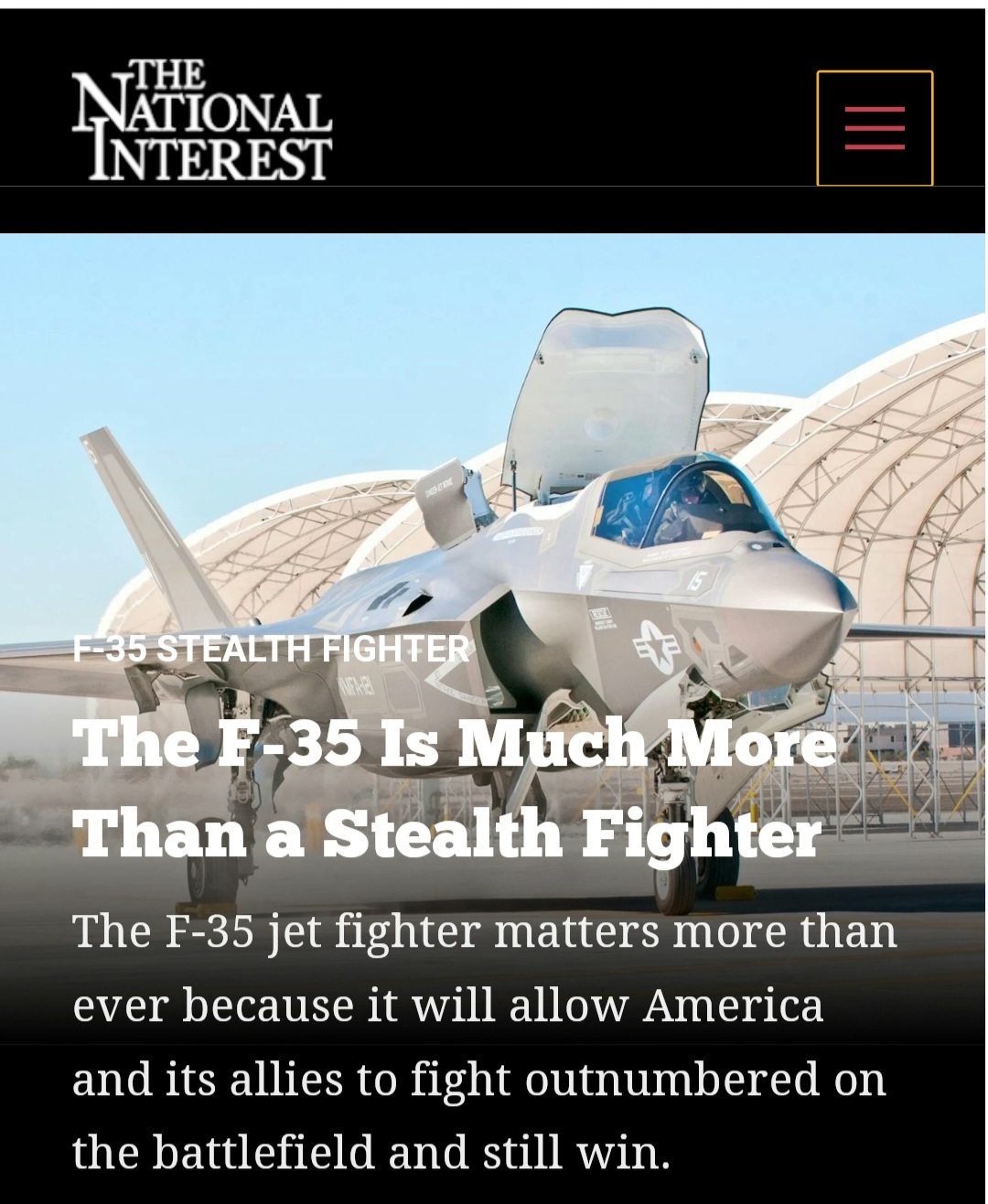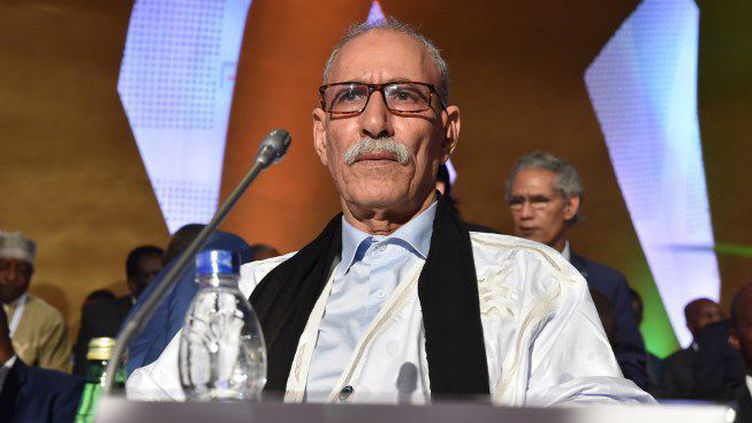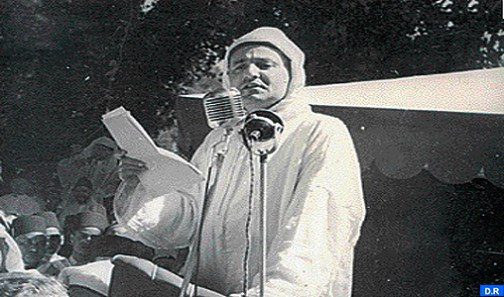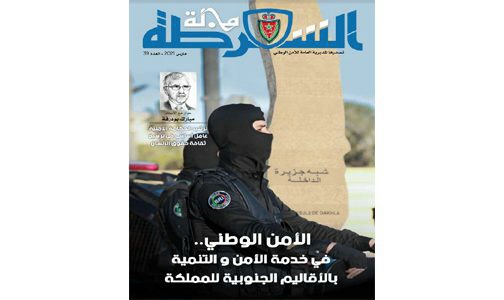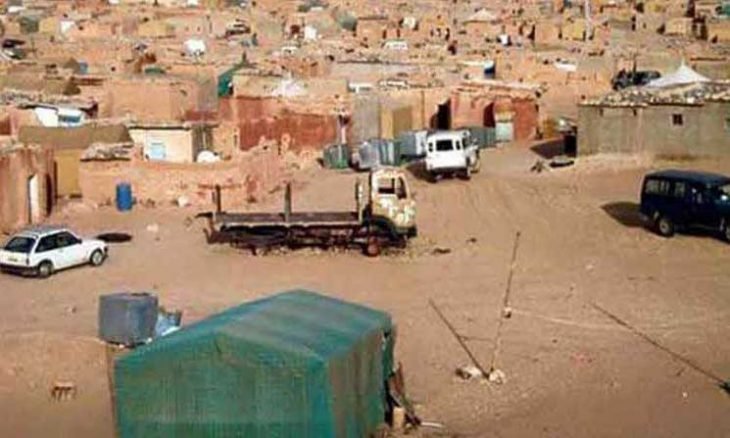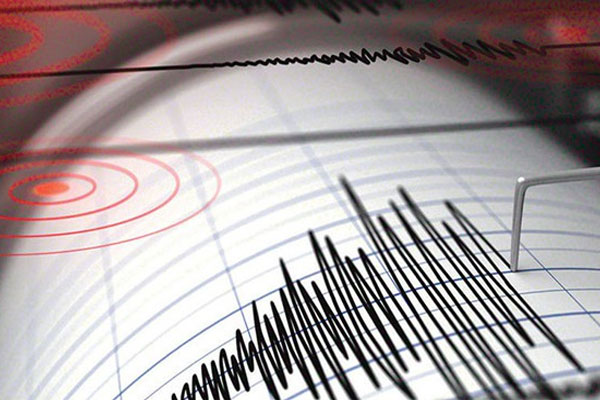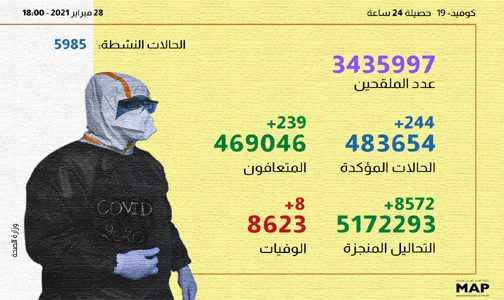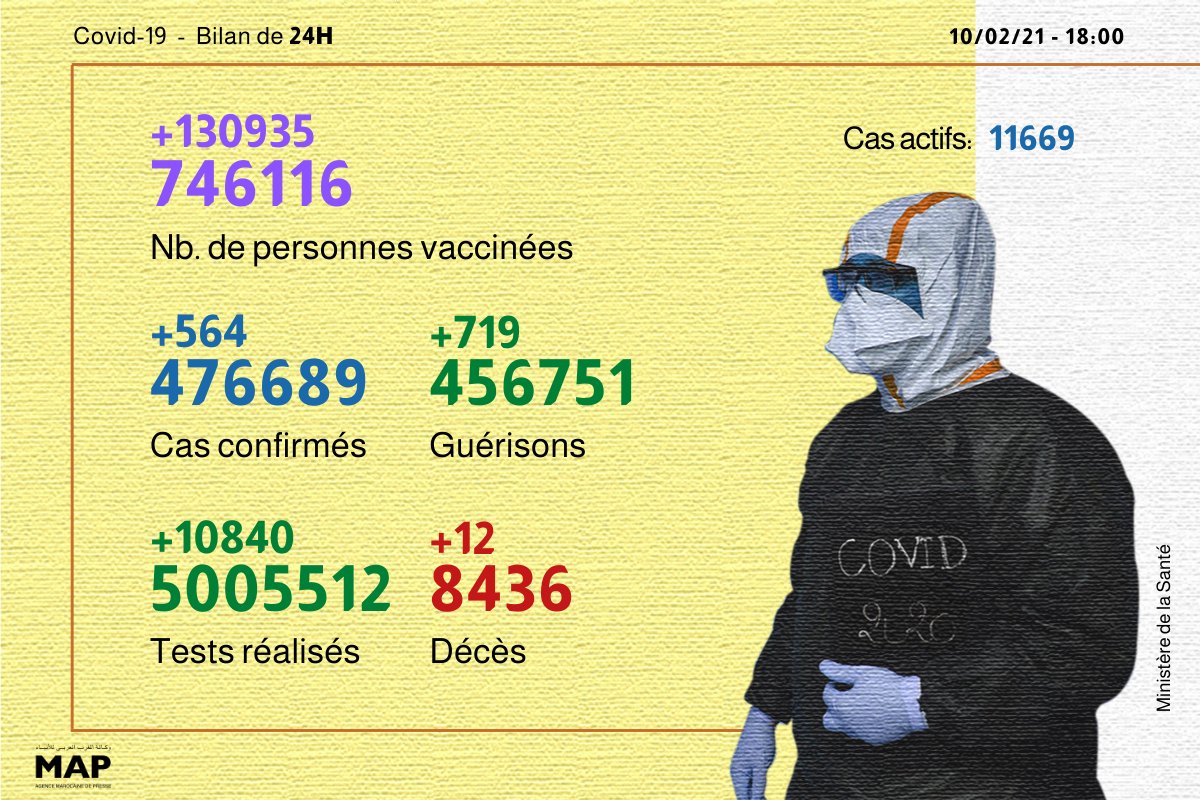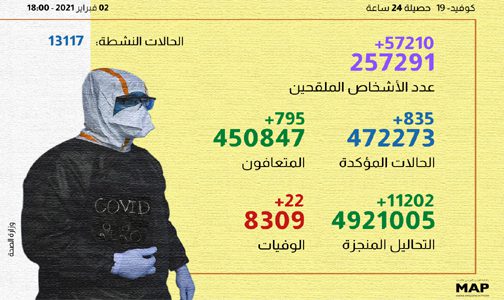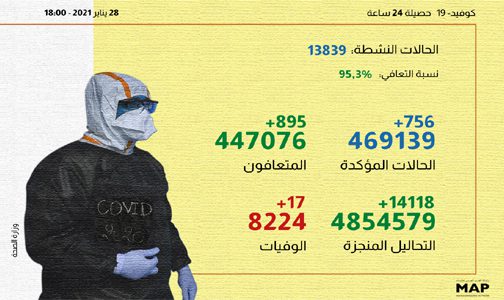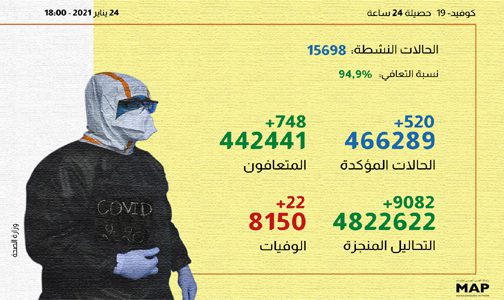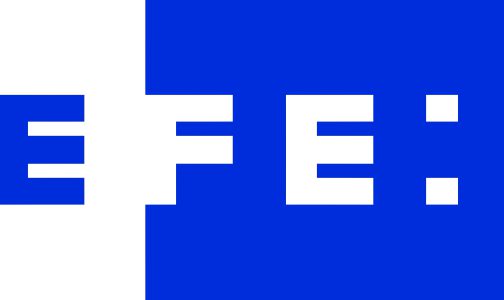بقلم الناشط الأمازيغي أحمد عصيد
الحوار الأخير الذي أجراه الأمير هشام العلوي مع إحدى المجلات الفرنسية في مستهلّ الشهر الجاري يثير أكثر من سؤال، ويطرح مدى مصداقية المواقف النقدية التي يتخذها الأمير ضدّ السياسات التي ينتهجها ابن عمه الملك محمد السادس.
وبغضّ النظر عن المرامي التي يسعى الأمير إلى بلوغها من وراء خرجاته الإعلامية النارية، فإنّ حدّة تصريحاته أصبحت تميل في نبرتها إلى ما يشبه الإنتقام الشخصي وتصفية الحسابات، مما يفقدها قيمتها النقدية الإيجابية، ويجعلها أبعد ما تكون عن التقييم الموضوعي الذي يرمي إلى تطوير التجربة الديمقراطية المغربية وإنجاحها، والدفاع عن المظلومين، وتفكيك “المخزن”، وإعادة الإعتبار لقيم العدل والحرية والمساواة.
وإذا كانت معظم الأفكار التي يعبّر عنها الأمير متداولة في الساحة الداخلية لدى منتقدي السياسات العمومية من المعارضين من كل التيارات والأطياف السياسية، ولا يقوم الأمير إلا بالتعبير عنها من موقعه ومن خارج المغرب وفي منابر إعلامية ذات شأن في الأوساط الدولية، فإنّ ما أثار اهتمام الفاعلين الأمازيغيين وأغاظهم لأول مرة من تصريحات الأمير، هو ارتكابه لخطإ فادح في حق الأمازيغ الذين ناضلوا على مدى 45 سنة من أجل أن يصلوا أخيرا إلى اعتراف أسمى قانون للبلاد بلغتهم وهويتهم التي عانت منذ الإستقلال من كل أنواع التحقير والتهميش.
يرى الأمير هشام العلوي، الذي لم يسبق له أن أدلى برأي في موضوع الأمازيغية أيام كانت تعيش سنوات رصاصها مع عمه الحسن الثاني، أنّ ما تمّ في المغرب من دسترة للأمازيغية هوية ولغة، لا يعدو أن يكون إحياء لما أسماه “الظهير البربري”، الذي حاول من خلاله الفرنسيون، حسب رواية الأمير، التفريق بين مكونات الشعب المغربي من “عرب و بربر”، لأن إقرار الدستور للتنوع هو في رأي الأمير مهدّد للإنسجام الإجتماعي ولوحدة الشعب المغربي، وهو بذلك يبرهن على أنه لم يبرح مدرسة “الجاكوبينيزم” الفرنسية ،التي تخرجت منها الطبقة السياسية المغربية المؤسسة للدولة المغربية الحديثة بعد الإستقلال، وهو النموذج الذي نحن بصدد تجاوزه في غفلة منه.
ولقد وقع الأمير بذلك في أخطاء ثلاثة: الأول أنه اعتقد بأن الذي أقر الأمازيغية لغة رسمية وهوية للمغرب، هو الملك محمد السّادس شخصيا وبشكل انفرادي، مما حمله على الإعتراض على ذلك من باب العناد وضدّ شخص الملك بالذات، بينما الصحيح أن الدستور صاغته لجنة مراجعة تلقت على مدى أسابيع اقتراحات الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني المغربي بمختلف مكوناته، ولم يتمّ إقرار الأمازيغية في الدستور إلا وفق ما طالبت به أغلبية المكونات المذكورة التي تقرب من تسعين في المائة، دون أن نعدّ المئات من جمعيات الحركة الأمازيغية التي لم تتعامل مع اللجنة، وكذا حلفاء الحركة الأمازيغية من اليسار الجذري كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي.
ولهذا فشل حزبا الإستقلال والعدالة والتنمية في سحب رسمية الأمازيغية من الوثيقة الدستورية خلال مساعيهما التآمرية في اللحظات الأخيرة قبل إعلان النسخة النهائية.
الخطأ الثاني أن ما ورد في تصريح الأمير يجعلنا نطرح أكثر من سؤال حول مدى إلمامه بتاريخ بلده، ومدى مواكبته للتحولات التي عرفها المغرب على مدى نصف قرن، وهي تحولات لم تصنعها السلطة بإرادتها، بل انبثقت من عمق الدينامية الإجتماعية المغربية، ومن تفاعلات عوامل إقليمية ودولية، مما يجعلنا نرجّح أن الأمير لا يعيش فقط خارج البلاد بل خارج السياق المغربي أيضا، هذا السياق الذي جعل الأمازيغية تبرز كرهان تنموي، وكأحد أسس المشروع الديمقراطي المغربي المستقبلي، القائم على حقوق المواطنة التي هي كل غير قابل للتجزيئ.
والخطأ الثالث أنّ إسقاط مفهوم “الظهير البربري” على قرار سياسي حكيم وديمقراطي ، يتضمن خلطا عجيبا بين السياق الكولونيالي الذي مضى عليه ثمانون سنة وبين الواقع المغربي الذي قرّر فيه المغاربة بأنفسهم وفيما بينهم إنصاف الأطراف المتضررة، ورأب الصّدع وإنهاء النزاع في موضوع ذي خطورة وهو موضوع الهوية والإنتماء.
وقد وعى بهذا الفرق حتى الذين كانوا إلى وقت قريب يحتفلون كل سنة بـ”الظهير” المذكور سواء في جريدة “العلم” أو على صفحات Le Matin وفق روايتهم السياسية المفبركة، التي كانت تهدف إلى ربط الأمازيغية إلى الأبد بالمشروع الإستعماري، وتوقفوا عن ذلك بعد أن تيقنوا بأن تجذر الأمازيغية ونهضتها لا يمكن مواجهتهما بتزوير التاريخ.
لقد برهن الأمير على أنه قد بقي في وعيه بالمغرب عند حدود 1999، السنة التي توفي فيها عمه الملك الحسن الثاني، الذي كان بمزاجه السلطاني وقبضته الحديدية، يعتبر أن أي ذكر للأمازيغية يعدّ إحياء للظهير المذكور، ولهذا لم يقدم أي تنازل في هذا الباب حتى تاريخ وفاته.
ويحكي لنا أحد الزعماء السياسيين المغاربة أنه في اجتماع للمجلس الوزاري عام 1979 قال الملك الحسن الثاني معقبا على من تحدث عن إنشاء مركز للدراسات الأمازيغية وافق عليه البرلمان بالإجماع آنذاك، إنه ليس مستعدا لإعادة إنتاج “الظهير البربري”، وهو قول ينضاف إلى قولة عز الدين العراقي في نفس المرحلة، والذي اعتبر أنّ فتح مركز “للبربرية” سيكون “وصمة عار” في جبين حزب الإستقلال. هذا هو المناخ الذي يبدو أن الأمير هشام ما زال يستلهمه ونحن في 2011.
ثم ما هي الوصفة العجيبة التي يتوفر عليها الأمير، والتي يعتبرها بديلا لترسيم الأمازيغية والإعتراف بالحسّانية الصحراوية؟ فالعبارات التي نطق بها تنطوي على الكثير من الخلط ويكتنفها الغموض، هل يريد الأمير أن يكتفي الدستور بالإعتراف الرمزي بالأمازيغية مكونا ضمن المنظومة العربية الإسلامية المهيمنة، حتى نضمن أن نبقى موحّدين بوصفنا “شعبا عربيا” منفتحا على تنوعه وتلويناته الفلكلورية ؟ إنها الوصفة الفرنسية التي قد ترضي بعض أبناء اليعقوبية الإستيعابية، وبعض بقايا القوميين العرب المتشدّدين، لكنها لن تفعل إلا أن تشعر الأمازيغ بمزيد من الإهانة و”الحكرة”، وهو أمر سيُسهم بكل تأكيد في تهديد الإستقرار السياسي للبلاد.
ثمّ لماذا اعترض الأمير على الأمازيغية والحسّانية فقط ولم يذكر البعد الأندلسي أو العربي أو اليهودي، هل هذه الأبعاد بديهية لديه إلى درجة إنكار ثقافة الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ، أم أنها اللعبة الطبقية القديمة التي يتحالف فيها الأمير مع بضع عائلات تستولي على 70 في المائة من المناصب الحسّاسة في الدولة ؟
هل يعلم الأمير بأن الخطاب الرسمي حول مغربية الصحراء كانت تنقصه الجدّية والصدق والحسّ الإنساني، لأنه كان يكتفي بالبلاغة الإحتفالية حول قطعة أرض دون أي احترام لثقافة وهوية الإنسان الذي يعيش عليها، والتي لم يكن لها أثر لا في الدستور ولا في التعليم ولا في الإعلام على مدى ثلاثين سنة ؟
ثم حتى نكون في منتهى الصراحة مع الأمير، نقول إنّ الذي يرمي بالحجارة من بيت زجاجي لا يمكن أن يوجد في وضعية مريحة، فالمصداقية السياسية تقتضي قبل كل شيء أن يتواجد صاحبها في موقع تبرئة الذمة من كل دين، والحال أنّ الأمير يتمتع خارج البلد بثروة طائلة من خيرات المغرب يعرف المغاربة مصدرها، مما يجعل عبارات الديمقراطية والمساواة والعدالة الإجتماعية في كلام الأمير أقل بريقا مما هي عليه عند غيره من المناضلين الشرفاء.
ثم على الصعيد السياسي العام، كيف يمكن الثقة في الخطاب الذي يقول إنه لم يوجد شيء ولن يوجد شيء، وأن الواقع المغربي يراوح مكانه في ثبات مطلق ؟ أليس في ذلك استخفاف بكل القوى الحية التي ناضلت داخل المغرب من أجل انتزاع المكاسب تلو الأخرى وتحصينها؟ أليس الأجدى أن نقف في موقع وسط بين خطاب “النكافة” المثير للسخرية الذي تتبناه السلطة والأحزاب الحليفة لها، وبين خطاب العدمية المطلقة والتشاؤمية السوداء المبني أساسا على النزوع الإنتقامي والرغبة في تصفية الحسابات؟ إن ما تحتاجه الساحة المغربية اليوم هو الموقف السياسي النقدي الموضوعي المبني على التحليل الدقيق للمعطيات، وعلى الوقائع الدالة والملموسة، وعلى تقديم البدائل التي تحرص على احترام الإنسان من حيث هو إنسان قبل كل شيء.